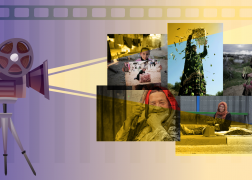من الضرورة أن نحتفي بدور المرأة على طول المسيرة الوطنية النضالية منذ الانتداب الإنجليزي، وأظن أنه قد أصبح معروفا للجميع الدور المهم والمحوري الذي اتخذته المرأة في مسيرة النضال، السلمي والمسلح. لكن الأهم هنا، وبرأيي، هو قصة المرأة، إنسانًا مشتبكًا، لا تكاد تنفصل عن واقعها الإنساني والثوري، المرتبط بالمعيشي، إن جاز التعبير.
فهل تنفك المرأة بأي حال عن إنسانيتها، سواء كانت اليد التي تحمل السلاح، أم التي دعت إلى حمل السلاح، المرأة التي استقرت في قلبها رصاصة فأردته، أو استقرت في قلب صغيرها فأهلكته، كأنما مات! أو ربما أسيرة هي، ورضيعها، أو أسيرة الحدود المجازية في عقلها وخيالها، وحبيبها في سجن أقصى الشمال أو أقصى الجنوب!
إنني أستذكر هنا، المرأة في الانتفاضة الثانية، التي اتخذت طابعًا مختلفًا، كما نعلم، إذ إنها كانت انتفاضة مسلحة، لم ينحصر فيها حمل السلاح على الرجال في الخلايا العسكرية، أو أذرع الفصائل المسلحة، فقد نفّذت 12 امرأة فلسطينية عمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي، ومن هؤلاء النساء الفلسطينيات؛ دارين أبو عيشة وآيات الأخرس وهنادي جرادات وسناء قديح وهبة دراغمة، وتعتبر وفاء إدريسي أولهن، وفاطمة النجار أكبرهن سنًا، إذ إنها أكبر امرأة فلسطينية تنفذ عملية فدائية وعمرها 57 عامًا، ووصل عدد الشهيدات إلى 460 امرأة واعتقال 900 امرأة.
هل دعوت لهما بالشهادة عندما طلبا من ذلك بإصرار؟ أكان من قلبك وروحك؟
ولكن السؤال الذي يبرز في ذهني هنا، في حيز الفضاء الفلسطيني الذي يقاوم، في تواجده وعيشه وصموده وانتفاضاته، في الإنساني، كيف للمرأة أن تحتفي بدم أو جرح، أو فقد. كنت أود أن أسأل أم الشهيدين عامر وعلي الحضيري، كيف تحتفين بقلبك فيهما؟ هل وددت لو بقيا حتى لو لم يُمنحا اختصاصًا كالشهادة؟
هل دعوت لهما بالشهادة عندما طلبا منك ذلك بإصرار؟ أكان من قلبك وروحك؟ أم كانت دعوة بحفظهما! لربما تلفظ قلبها بما لم يستطع لسانها قوله؛ لا بأس إن آلمتما عدونا، ولكن عودا، عودا وإن كنتما أسيرين، أعلم أنكما تستنشقان ذات الهواء. كيف يتمثل الحزن في قلبٍ موقن، أنهما ذاهبان لا محالة، يطلبان دعوة أمهما ويذهبان، يودعانها برسالة عبر الهاتف أن سنراك في الجنة، فإلى لقاء! وهل يعزي قلبها؟
ولا أستطيع الدنو من قلب لا يمكن أن أفهم حزنه أو أن أكون مكانه، من أم الشهيد عماد سليمان، لقد استشهد قبل عرسه بأيام، وهي تعلم يقينًا أنه سائر في درب الشهداء. لم تسألونهن إذن بماذا يشعرن؟! تبًا، وكيف للأم أن تشعر؟ هل شعور يُقاس عليه! وماذا ستقول لمن يحتفون بدماء صغيرها؟ فهم الشهداء!
أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها.. أجمل الأمهات التي انتظرته.. وعاد مستشهدًا.. فبكت دمعتين ووردة.. ولم تنزوِ في ثياب الحداد.. آه.. آه.. آه.. لم تنته الحرب لكنه عاد.. ذابلة بندقيته ويداه محايدتان.. أجمل الأمهات التي انتظرته وعاد..
أجل يا درويش، إن عودته أجمل، أجمل من أن نزين صوره في الحارات والشوارع، أجمل أن يُطبع نعيه في الصحف، أجمل من تأبينه وسط آلاف البشر، أجمل من مناداة اسمه في مضخمات الصوت هنا وهناك! وليكن شهيدًا في قلب أمه!
ولكن لا يغلب الشهادة إلا عزاءاتها، ولا أدري أيهما أكثر قداسة، كلاهما وطن، وفقدانهما منفى، وحين يعزف البارود لحن الفقد، يجيبه صدى الأرض التي تضمه شهيدا، ويا ويح قلب أمه، ماذا عساها أن تجيب! وأيّ لحن سينشد، وكيف هو صوته؟ لحن بترانيم نسمع بعضها، والآخر يبعثره الفضا؛ فأنا له أن يُسمع! وصوته نحيب عذب يسجد تحت العرش!
وإن ننسى فهل ننسى أم الشهيد محمد المصري، "إن للقدس غيرك يا ولدي". "أفلا أكون أولهم وثانيهم وثالثهم يا أماه"، وكان قد كتب على حائط الفيس بوك خاصته: "إحنا عشاق البارود، وباسمك نعلي الراس، دونها يا رصاص، دونها واحكي للأسود نحن بالدم نجود"!
لا تطلبوا منها أن تزغرد إذن، لا تطلبوا منها أن ترش وردًا وحلوى، ولا تطلبوا منها أن تبكي، دعوها تتشح بما شاءت، فلا أقسى ولا أكثر وجعًا من ذلك، ولسنا في موضع نستطيع فيه أن نقيس درجه الألم، طبيًا أو فلسفيًا. أود أن أحمل السلاح عنه ولا أفقده، وأريد أن أحمل السلاح وأفنى وإياه، فلا يكون حزنًا أبدًا على شهادة. وكيف لنا أن نحكم على ألم الفقد في فرادة التجربة وذاتيتها، في فعلها الإنساني المحض؟
وهناك من قال إن "العذاب لا يكتفي بأن يكون، وإنّما أن يكون بمبالغة. والعذاب يكون دومًا عذابًا مفرطًا، ومن ثَمّ فمفارقة العلاقة بالآخر تصبح عارية. من جهة، أنا الّذي يتعذّب وليس الآخر، ومكانانا غير قابلَين للتبادل، ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من كلّ شيء، ومن الانفصال، فإنّ العذاب الّذي يظهر في الشكوى هو نداء للآخر، وطلبٌ مستحيل إرضاؤه؛ ربّما لعذاب لا حدود له".