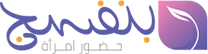لا شك أن العيش في الوطن نعمة كبيرة ومنحة عظيمة، خاصة إذا كان الوطن مغتصبًا تشتت الكثير من أبنائه، وصار أكبر همهم أن يستنشقوا هواءه أو يلمسوا ترابه ولو لمرة واحدة في حياتهم، ومع أن العيش فيه صعب في ظل الاحتلال، إلا أنه لا يخلو من شعور ما باللذة والهناء، فكل شيء فيه له نكهة مميزة، بدءًا بالطعام بصنوفه وأشكاله، وانتهاءً بهوائه العليل، ومناظره الخلابة، وطبيعته الساحرة، التي تكاد تختلف وتتجدد كلما صعدت جبلًا أو هبطت واديًا.
لقد عدت وطني في أواخر مرحلة طفولتي، وإذا بي أشعر بغنيمة أن أسكن الوطن، إذ حرمت منه لسنوات، وذلك جعل أي رحلة صغيرة أسافرها عبر وطني متعة لا تعوض، فلا أبخل على نفسي باستنشاق الهواء العليل بعمق، ولا أدع النظر في كل جانب، الجبال والأشجار، الأعشاب والأزهار، الرعاة والمواشي، الطرقات والمباني، أتصفح وجوه الناس والغيمات في آن معًا، ولا أنسى أن أستمع إلى الأصوات ملء أذني، أصوات النسائم والأشجار والأطيار في البرية، و ضجيج المارة والباعة والسيارات داخل المدن، إنني أبحر في كل ذلك، وأدرك النعمة التي أحيا فيها، نعمة العيش في حضن الوطن.
ولا يقطع إبحاري الجميل في كل هذه الروائع من حولي، إلا تلك المباني المختلفة الطراز، المصفوفة بجانب بعضها البعض على نحو منظم بتطرف، والتي تأكل الطبيعة من جوانبها كل يوم، حتى غطت في بعض المناطق جبالًا كاملة، كما أنها أحيطت بأسيجة مزدوجة وكاميرات، وتجند لها الحراس الذين يحكون لغة مختلفة عن لغة هذه الأرض، إنها المستوطنات الإسرائيلية، التي تأكل ما برحت تأكل الأرض، أرض الفلاح الفلسطيني الذي طالما سقاها من عرقه، يوم حرثها، أو زرع بذرا في بطنها، أو قطف زيتونها، وزعترها، أو رعى حلاله فيها، إنها تتشظى، وتتفشى كالمرض السرطاني!
إن رحلة قصيرة بين قريتي وقرية أخرى مجاورة لا تتعدى العشرين دقيقة بالسيارة، تجعلني أمر بمستوطنات متعددة، بعضها صناعي، وبعضها سكني، وفي البداية، كان يمكنني رؤية مدخل إحداها، وبعض الإضاءة البعيدة على رأس المرتفع، ثم ازدادت الإضاءة وامتدت شيئًا فشيئًا، وفي غضون شهور قليلة، كانت مصانع بالغة الضخامة تمتد كل يوم منحدرة نحو الشارع الذي نمر من خلاله، حتى غطت سفح الجبل الذي كان ينبض بالخضرة والنضارة، بمبانٍ اسمنتية وحجرية ومعدنية، وافتتحت شبكة من الشوارع المدعومة بالجدران الاستنادية، ولم يتبق للجبل من معالمه شيئًا إلا الارتفاع.
أعتقد أن حزني يتعالى على حزن الأحجار التي قلعت، والأشجار التي قطعت، والأعشاب التي سحقت.
والجبل المقابل له على الجانب الآخر من الطريق كان فارغًا تمامًا من كل أشكال الوجود البشري، لكنه كان من أجمل المراعي التي تقصدها المواشي كل صباح. سرب من الأبقار هنا، و قطيع من الأغنام هناك، تم اغتيال طبيعته، فقد اعتلته جرافات تابعة لشركات عبرية، و بدأت تعمل فيه مخالبها حتى سيطرت على كل جانب فيه، و جعلته مدرجًا من القطع الأرضية المنبسطة، التي بني عليها عدد آخر من المصانع الكبيرة، و التي حملت لافتاتٍ باللغة العبرية، معلنة امتلاك أصحاب هذه المصانع للحق في هذه البقعة التي مررت إليهم سرقةً واغتصابًا.
وفوق ذلك كله، تظهر لي بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بالعبرية، تدعو اليهود إلى الشراء والاستثمار في هذه المناطق المغتصبة، ويبدو أنها تظهر لي بواقع الموقع الجغرافي، وهي دعوات ليست موجهة إلينا بكل تأكيد، لكنها تظهر مدى استهتار هذا المحتل بحقنا، بل تحديه لنا بقوته و جبروته وقدرته على قهرنا.
خطواتي وطرق المارة المشاة، في كلا الجبلين الذين لا زلت أمر بينهما كانت كالخنجر في صدري، كما هي في صدر الوطن كله، وحزن عميق أشعر به، ولا أعتقد أن حزني يتعالى على حزن الأحجار التي قلعت، والأشجار التي قطعت، والأعشاب التي سحقت، والمواشي التي حرمت، ولا زال هذا السرطان الصهيوني يتفشى في جسد وطني الجريح فلسطين، دون ساكن يتحرك على الموائد المستديرة، بينا يمعن الاحتلال في تقطيع أوصال هذه الأرض دون رحمة.