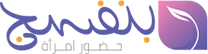أحد المشاهد الأثيرة جداً في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم فتح مكة لما سأله الصحابة أين يريد أن يقيم وهو قائد الجيش المنتصر الفاتح الذي تأتيه مكة قاطبة تطلب عفوه، فلو أراد أن يقول أخرجوا أبا سفيان من داره وأجلسوني فيها لقال وفعل، لكن له في مكة مكاناً آخر، يأتيه في تعاظم قوة الإسلام، يتقاسم معه نصر الدعوة بعد أن أتى صاحبته ينشد الطمأنينة من فزعه منادياً "دثروني دثروني.. زملوني زملوني"، فآوته في قسمها له حين انفض من حوله الناس وكذبوه :"والله لا يخزيك الله أبداً".
إنها خديجة، المسلمة الأولى، والسند القوي، والأمان الرحب للنبي في أيام نبوته الأولى، خير نساء الأرض وأصل أول بيتٍ في الإسلام، يعود النبي إلى مكة في أوج قوته بعد رحيلها بأحد عشر عاماً وقد رحلت عنه في أيام شِديدات على الدعوة، فيشير على صحابته بأن أقيموا خيمتي هنا، عند قبرها الذي كان أول قبر هبط إليه النبي في حياته يوم وارى فيه حبيبة قلبه، المرأة التي آواه قسمها، وإيمانها به.
يأخذني سحر النبي في سيرته في مواقفه الإنسانية، وأولها قاطبةً قصصه مع خديجة رضي الله عنها، وكأنه يؤسس لنظام اجتماعي في العلاقات الإنسانية يحفظ به علينا سموَّ بشريتنا، فتجده يحفظ الفضل لها في لحظةٍ مزدحمة وفارقة في تاريخ الإسلام كلحظة فتح مكة، لحظة خصبة بأن ينشغل بالغنائم أو الاقتصاص ممن ظلموه، لكنه يقول أقيموا لي عند قبر خديجة.
إنها تربية النبي لنا في تفضيل ما هو إنساني نبيل دائم الأثر، على ما هو ماديٌّ مؤقت القيمة، ومدرسة عظيمة في أسس العلاقات الإنسانية التي تتجسد في أقدس صورها بالحب الذي هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع الإنساني السويّ، وحجر الزاوية في إقامة بناء متماسك للمنظومة المجتمعية، من أبسط صورة لها، رجل وامرأة فأسرة، إلى أعقدها وأكثرها تداخلاً، دولة وقوة سياسية اقتصادية مبنية ضمن منظومة أخلاقية متزنة، تحقق التقدم والنهضة والحضارة، وتحفظ معنى الإنسان الروحي دون تشوه بفعل المادة.
| عن أيام خديجة!

الحب، العلاقة الإنسانية الأكثر تأثيراً في مسار حياة أي واحد منا، لأنه ضمن المنظومة الاجتماعية السليمة أساس مهم تقوم عليه مؤسسة الزواج، وبالتالي المجتمع، وبالتالي الدولة، فإن هدي النبي فيه يتلخص بعظمة في واحدٍ من أجل مواقف القائد الإنسان، حين فرش عباءته لعجوز أقبلت عليه وسط زحام الناس يوم فتح مكة، جلسا عليها يتحادثان رغم كل ما يكتنف تلك اللحظة من تفاصيل فارقة في حياة الدولة السياسية، وعن ماذا يتحدثان؟
عن خديجة التي اتكأ عليها حتى وصل هذه اللحظة، فلما بلغ لم ينس الفضل، ولما قيل له :" إن الله أبدلك خيراً منها" غضب حتى بدا عرقه الهاشمي، وقال: "والله ما أبدلني الله خيراً منها، آوتني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس".
مدرسة النبي في العلاقات الإنسانية، والتي ارتكزت دائماً وفي كل مواقفه على صفاء القلب واتساعه، وعدم الاشتراط في العطاء، واضحاً بسيطاً صادقاً، هي وحدها المخرج الحقيقي الآمن لنا من مأزق التشوه الذي يتفشى في علاقاتنا الإنسانية اليوم التي باتت تحتكم في أساسها للبعد المادي الطاغي بحكم تسارع الحضارة المجنون، وصارت تنجح بحضور مظاهر مادية تدلل عليها، وتفشل بغياب هذه المظاهر، وتحوّل الناس في هذا الزمان لعبيد لشكليات العلاقات، بعيداً عن فقه مقاصدها والحرص على سلامة وصلابة جوهرها الذي به تستمر العلاقات، وتقام المجتمعات.
ويبدأ مدرسته من بيته، من خديجة، فيظل يذكرها وفياً لها، ويكرم صاحباتها إكراماً لما بذلته له من قلبها، والبذل من القلب والعمر أعظم شأناً من أي بذل مادي، ذلك أنه متصل بسمو الروح، والروح السامية متصلة بالسماء! ويستمر يرسي دعائم مدرسته أولويتها سلامة القلوب، فتجد الرجل العظيم يبدأ أول طريقه الشاق من بيته، من حجر زوجته في ساعة خوفه، من موقفها الحقيقي الثابت وإيمانها اللامشروط به، لا من مالها ولا شكلها، وإن كان مالها قد أعانه في دعوته، فإن قلب صاحبة هذا المال كان أصل العون.
وفي كل موقف نبوي، يقدم النبي درساً أن نقاء العلاقة الإنسانية من المصلحة الدنيوية أساس بناء المجتمع الإسلامي المتماسك، ويرسخ النبي أن قيمة الإنسان الحقيقية التي يؤخذ بها أولاً في المنظومة التي يعيش فيها، هي قيمته الخُلقية وما يمتثل له من مبادئ، لا ما يملكه من موجودات مادية من المحتمل فناؤها في أي لحظة.
والحب، العلاقة الإنسانية الأكثر تأثيراً في مسار حياة أي واحد منا.
وبهذا الهدي كان يوجه صحابته فكان أول ما قام به في المدينة المنورة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، مُذيباً بهذه المؤاخاة أي فروق مادية قد تزعزع استقرار نواة الدولة الناشئة في المدينة، ونازعاً لفتيل أي أفكار تجبلها المادية في النفوس البشرية من عنصرية أو فوقية، فتجده يقول عن العصبية القبلية :"دعوها فإنها منتنة" والعصبية التي إن تأملت في كيفية نشوئها تجد شيئاً كثيراً منها يكبر في النفس البشرية حين يفتنها المال والرجال والقوة الضاربة، وهذه كلها مكونات مادية تحرف مسار العلاقات الإنسانية باتجاهات مؤذية إن لم تكن منضوية تحت معنىً إنساني متسع نبيل، متصل بالنزعة الروحية للإنسان، وما يحتكم إليه روحياً في حياته.
والحب، العلاقة الإنسانية الأكثر تأثيراً في مسار حياة أي واحد منا، لأنه ضمن المنظومة الاجتماعية السليمة أساس مهم تقوم عليه مؤسسة الزواج، وبالتالي المجتمع، وبالتالي الدولة، فإن هدي النبي فيه يتلخص بعظمة في واحدٍ من أجل مواقف القائد الإنسان، حين فرش عباءته لعجوز أقبلت عليه وسط زحام الناس يوم فتح مكة، جلسا عليها يتحادثان رغم كل ما يكتنف تلك اللحظة من تفاصيل فارقة في حياة الدولة السياسية، وعن ماذا يتحدثان؟
عن خديجة التي اتكأ عليها حتى وصل هذه اللحظة، فلما بلغ لم ينس الفضل، ولما قيل له :" إن الله أبدلك خيراً منها" غضب حتى بدا عرقه الهاشمي، وقال: "والله ما أبدلني الله خيراً منها، آوتني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس". ويستمر النبي يربينا، حين قال في غزوةٍ من غزواته بحزن بالغ :" إني افتقد جليبياً" ثم يوسد جليبيب ساعديه وهو شهيد في تلك الغزوة يقول :"جليبيب مني وأنا منه". الرجل الغريب، ذميم الخلقة، قليل المال، عظيم الإيمان، وصادق العزم الذي أرسل النبي لبيت من بيوت الأنصار أن زوجوه، فلما تلكأ الرجل وزوجته في أمر ابنتهما قالت:"أتردون على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمره، ادفعوني فإنه لم يضيعني".
إن النبي في هذا الموقف يجسد معنى السمو الإخلاقي في مواجهة الفكر الاستهلاكي في إقامة العلاقات الذي يعامل العلاقة بأنها استثمار فيما يملك الإنسان من ماديات، وهذا هو الإيذاء الحقيقي في العلاقة وهو ما بات اليوم منتشراً بطريقة مرعبة في ظل صعود المعاني المادية على حساب الروحية. وفتاة جليبيب تلك كانت الصورة المبهرة للتواضع والشجاعة والانضباط والإيمان بمعانيها الحقيقية، امتثالاً للأمر النبوي.
إن النبي قدم بسيرته التأسيس الحقيقي للمضمون التراحمي والغيبي لجوهر العلاقات الإنسانية، المقرون بالأجر العظيم -الغير ملموس مادياً- في كل أشكال العلاقات، فتجد النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث القدسي: "حَقَّتْ مَحبَّتي للمُتحابِّينَ فيَّ، وحَقَّتْ مَحبَّتي للمُتزاوِرينَ فيَّ، وحَقَّتْ مَحبَّتي للمُتباذِلينَ فيَّ، وحَقَّتْ مَحبَّتي للمُتواصِلينَ فيَّ"، وفي نص حديث آخر أن المتحابين في الله ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتصور هذا الفضل العظيم في ذلك الموقف الشديد -يوم القيامة-، يدلل على عظمة الفعل ونبله.
وبتأمل تسلسل مواقف النبي في علاقاته وما أسسه من علاقات في المجتمع المسلم وما ربّى عليه الصحابة، تجد دائماً بُعداً غيبياً في فضل العلاقات النقية والثواب عليها، أضف لذلك ما قدمه في مدرسته العظيمة من تأكيد مستمر على أن نقاء العلاقات الإنسانية وسلامتها أمور تتفوق على أي أمر مادي، فتجده قال لصحابي أن يعود ليجاهد في أمه وأبيه وألا يخرج للقتال مع جيش المسلمين، وتجده يجسد معنى الرفق بمداعبته الحسن والحسين.
ويأتيه رجل فيقول له:" يا رسول الله إني أحب فلاناً، فيقول له :"هل أعلمته؟ فيقول الرجل: لا، فيرد عليه النبي أن اذهب أعلمه أنك تحبه"، الحب اللامشروط، والنقي، وهو الحقيقي الذي يجده الإنسان حين تضيق به الحياة أو تطحنه ابتلاءات الزمان. يرسخ النبي مبدأ أن سلامة قلب الإنسان، وحفظ كرامته إنساناً قيمته إنسانيته لا مادية ما بين يديه من شكل أو مال، هي أهم مقصدٍ من مقاصد الإسلام، وتأتي الزواجر القاسية لما قد يُمارس من أذىً يهدد سلامة استقرار المجتمع واتزان علاقاته، وأي ممارسة لامتهان كرامة الإنسان عبر بوابة العلاقات.
لقد أرسى القائد العظيم كل هذا، حين كان محباً صادق الحب، وانطلق في هذا من حجر خديجة، يوم أتاها خائفاً، فآمنته، ومن مثل خديجة؟ وإنه لما قال:" إني رزقت حبها"، فإنه بهذا الرزق اتسع عليه الصلاة والسلام، فتحمل مشاق الدعوة، وكابد عناء التنكيل، وحمل بهذا الحب عبء الأيام الثقال حتى بنى دولةً أعادته إلى مكة مع مقاتليه، فعاد أول ما عاد، إلى خديجة. إلى ذكراها، إلى "إني رزقت حبها".