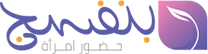سأحدثكم عن التعلم والتعليم في نيوزيلاند، وتحديدا المرحلة الأساسية وليست الثانوية، والتي يعد التعليم الأساسي فيها ضمن العشرة الأولى، وفق تقرير التنافسية العالمية الأخير[1]. في كل مرة سأتحدث عن جانب مرتبط بالتعليم، مثل: المناهج، والتقييم، والمواد الدراسية، والأنشطة، وغيرها من المواضيع المرتبطة بالتعليم، في هذا البلد المنعزل عن العالم.
وكونه بلد ينتمي للعائلة البريطانية، فقد ورث الكثير من مكتسبات تلك العائلة، سواء على صعيد اللغة أو الثقافة أو التصنيف الحضاري، كبلد ينتمي للعالم المتقدم. ومن الخصوصيات الهامة لهذا البلد أن السكان الأصليين "شعب الماوري" استطاعوا بالكثير من النضالات، كحال جميع الشعوب التي خضعت للاستعمار البريطاني، أن يثبتوا وجودهم ويبرزوا ثقافتهم، لتصبح رقما صعبا لا يستطيع أحد تجاوزه، أو المساس به، على عكس ما حدث للأسف الشديد، لشعوب أستراليا وأمريكا الأصليين، من إقصاء وتهميش. وإنّ هناك سببين لأحدثكم عن هذا الموضوع: شيء من المشاركة، وشيء من التغيير.
| شيء من المشاركة

كوني أم وباحثة في مجال التعلم والتعليم؛ فإن النظام التعليمي في نيوزيلاند فاجأني، وما زال يفاجئني كل يوم. فقد كنت أعتقد أن خبرتي سواء كمعلمة، أو متعلمة، أو باحثة، قد أعطتني تصورا وفهما معقولين، لكثير من المفردات المستخدمة في مجال التربية.
فقد عشت شخصيا وعايشت مع أبنائي تجربة التعلم والتعليم في ثلاث دول عربية، سواء في مدارس خاصة، أو حكومية، مع دراسة مناهج عربية وأجنبية. كما أن كوني باحثة في التربية، وأعيش في الحقبة الرقمية، جعل من المتاح لي بضغطة زر، مثل الضغط على هذا الرابط مثلا، الدراسة والاطلاع على تجارب العديد من الدول في العالم: كاليابان، وسنغافورة، وكوريا، وفنلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، سواء من خلال قراءة الأبحاث، أو الكتب، أو مشاهدة الوثائقيات، وحتى المسلسلات.
وبالرغم من أن ذلك الاطلاع ساهم بشكل كبير، في توسيع مفهومي وإدراكي، للكثير من الجوانب المتعلقة بالتعلم والتعليم، إلا أن التجربة التي أعيشها الآن تتحدى وتغير بشكل جذري، كلّ مفاهيمي وتصوراتي السابقة، لربما لأن التعليم في نيوزيلاند، مختلف عن أنظمة التعليم المشهورة والشائعة في العالم، حتى وإن تشابه معها في بعض الجوانب.
وكمؤشر لهذا الاختلاف، فإن عددا غير قليل من أصدقائي وزملائي، من الذين درسوا أو عاشوا في بعض الدول الأوروبية، أو الأمريكية، كانوا يواجهون صعوبة في تخيل، أو استيعاب، أو فهم، الحياة المدرسية ونظام التعليم هنا، حين أصفها لهم. وكان من الطريف أيضا، أن دكتورة وباحثة نيوزيلاندية في التربية، عبرت أيضا عن اضطرارها الدائم لشرح طبيعة التعليم والسياق النيوزيلاندي، حين تكتب أبحاثها لتنشر في المجلات البحثيةـ لأن المحكّمين، وهم عادة متخصصون في التربية من شتى دول العالم، ومع ذلك، يبدون وكأنهم لا يعرفون عن ماذا تتحدث!
لذا اسمحوا لي مشاركتكم نموذجا مختلفا بشكل كبير، عما ألفناه وعهدناه في مجال التربية والتعليم في العالم العربي. وهذه المشاركة هي ما تقودني الآن إلى السبب الثاني لكتابة هذه السلسلة من "تعليم المقهورين".
| شيء من التغيير

ماذا يحدث لنا حين نسمع كلمات مثل: المدرسة، المدير، المعلم، الصف، الشهادات، الفرصة، اجتماع المعلمين والأهالي؟
يبدأ الذهن باستحضار تفسيرات، وتصورات لهذه الكلمات، نشأت في معظمها نتيجة للتجارب والخبرات التي مررنا بها في حياتنا، سواء في المدرسة أو الجامعة، وأعطت لتلك الكلمات معنى وتصورا راسخا. وقد نكون محظوظين كوننا نعيش في العصر الرقمي، وبالإمكان تجاوز الزمان والمكان والقيام بالقراءة والاطلاع، أو حتى مشاهدة تجارب مغايرة للتعليم في هذا الكون، بما يضيف، أو يغير، أو يعدل، من تلك المعاني الموجودة في الأذهان. لكن بالطبع، لا يمكن لما سبق أن يعدل في قوة تأثيره، وانعكاس التجربة الذاتية التي نحياها، ونعيشها، ونعاصرها. ومع ذلك، فإن الاطلاع قد يساعد ولو قليلا، على تغيير معنى ومفهوم تلك الكلمات.
تشير بعض الدراسات، إلى أن فرصة حصول تغيير حقيقي في تصوراتنا، تحدث حين نمرّ بتجربة تتحدى كل ما ألفناه، وما علمناه، وما مررنا، به أو قرأنا عنه، تجربة مختلفة تماما، وكأنك في عالم أو كوكب آخر. فنقع في خليط من مشاعر الحيرة والاضطراب والقلق والشك. وقد تكون ردة فعلك تجاه المفهوم الجديد الذي يتحدى مفهومك القديم: إما الرفض التام. أو القبول الكامل. مشاعر متضاربة، وردود الأفعال تواجهك وتغمرك، ستؤثر فيك بشكل أو بآخر، حتى لو لم تلاحظ أو تعترف بذلك. فعلى أقل تقدير ستخلق في ذهنك معنى جديدا أو إضافيا للكلمات، لم تعرفه من قبل. إنّه لمن المثير حقا، أننا نحن البشر لا نبتكر المفردات فقط، وإنما نبتكر ونغير في معانيها.
إن هدفي ببساطة يكمن في خلخلة تصوراتنا الراسخة عن التعليم: إقلاقها، إزعاجها، تحديها. تلك التصورات التي حفرت في وعينا، وبات من الصعوبة تصور مناهج بلا كتب، أو شهادات دون علامات، أو عاماً دراسياً دون امتحانات.
إنّ هذه التجربة تحدّت كل معرفتي، ومفاهيمي، وخبرتي، وتجربتي في عالم التربية والتعليم والتعلم، وأوقعتني في بحر من الحيرة والاضطراب والتساؤلات اللامتناهية، وأثرت فيّ بشكل كبير. فمعنى كلمة مدرسة، لم يعد فقط المدرسة التي أعرفها في فلسطين، أو الأردن، والشهادة لم تعد تلك الورقة المليئة بالأرقام، والمناهج لم تعد تلك الكتب المدرسية. أصبح هناك تصور آخر، ومعنى جديد لكل تلك الكلمات. هذا التغيّر في تصورنا لجوانب التعليم المختلفة، قد يساهم "أحيانا" في إحداث تغير ملموس، في واقعنا وحياتنا ومجتمعاتنا، خاصة إن كان التغير متعلقا بجوانب أساسية، ومصيرية، تتعلق بالربح والخسارة [2]، ولست أدري ما الذي يمكن أن يكون مصيريا لنا كمجتمعات، مثل ربحنا أو خسرتنا في مجال التعلم والتعليم لأبنائنا والأجيال القادمة؟
| ابتياع الوهم

أتذكر برنامج "خواطر" للشقيري، وأتذكر حجم التأثير الذي صنعه في الكثير من الجوانب. ولكن، لا يمكننا أن ننكر أيضا أن أقصى ما استطاع فعله البعض منا هو تغيير رنة جرس المدرسة، لتشبه رنة المدرسة اليابانية. هذه الرنة للأسف لم تغير طريقة التدريس العقيمة، ولا المناهج الفاشلة، ولا خففت ضجر الطلبة ولا عناء المعلمين.
لهذا، أكثر ما أخشاه، وأتوقعه في نفس الوقت، هي عقلية الترقيع، والنسخ واللصق المعشعشة في أذهان البعض. نستورد فكرة تربوية من نظام وسياق مختلفين، ونطبقها في أنظمتنا البالية، ونتوقع نتائج. ومن الآن أقول، هذا لن ينتج إلا أنظمة مرقعة فاشلة في تحقيق أي شي نافع، كما يزيد من أعباء المعلمين والطلبة والأهالي. مثل المشروع الذي قامت به وزارة التربية في فلسطين، حيث فرضت طريقة التعلّم بالمشاريع في المدارس، أو فكرة ملف الإنجاز. هذه الأفكار لن تنجح أبدا في نظام تعليمي مركزي، يعتمد على التلقين والعلامات. حيث كانت نتائجه، مصائب حقيقة، وأعباء كبيرة على أولادنا الذين طلب منهم خلال فصل دراسي واحد، عمل سبعة مشاريع، لسبعة مواد، كلها عبارة عن نسخ ولصق من الإنترنت.
كما أنه من المهم أن ندرك، أن أي نظام تعليمي في العالم "الفنلندي والسنغافوري والنيوزيلاندي" له حسناته وسيئاته، وله نقاط قوة ونقاط ضعف، ويواجه تحديات كبيرة وحقيقية، وكل نظام يكافح بشدة ليحصل على النتائج المرجوة، وهذه الجوانب سأحاول أن أشير إليها ما استطعت، لكي لا ننجر إلى دوامة الانبهار الأعمى. صحيح أن تلك الأنظمة المميزة استطاعت أن تنافس دول العالم في الجودة، لكن المفاجأة هي أن هناك فرقا كبيرا جدا بين النظام السنغافوري والفنلندي والنيوزيلاندي، فرق في كل شيء. لكن، كل واحد منها أثبت جودته وجدارته، لأنه باختصار صمم كنظام متكامل، ليراعي خصوصية مجتمعه الثقافية وظروفه الاقتصادية والجغرافية والسكانية، وليلبي حاجات وطموحات المجتمع ككل.
ما أستطيع قوله من خلال دراستي للنظام التعليمي النيوزيلاندي، أنه ساعدني كثيرا على تغيير نظرتي القديمة للتربية، وأولويات عملية التعلم والتعليم، لكن هذا لا يعني أبدا، أن علينا أن نتقمصه بالكامل. وإنما يعني أنه خيار يمكن أن نتعلم ونستفيد منه، ليكفينا عناء اختراع العجلة من جديد. كما يعني، أنه وغيره من الأنظمة يمكن أن يوسع ويثري خياراتنا، وتصوراتنا حول العملية التربوية، على أمل أن يساعدنا غدا على تصميم نظام تربوي أصيل، يشبهنا ويعبر عنا، يحل مشاكلنا، ويعالج عيوبنا، ويستثمر طاقاتنا ويلبي طموحات شعوبنا، ويظهر أجمل ما فينا، ويعيد الثقة بأنفسنا إلينا. إن التغيير الحقيقي للنظام التعليمي في بلادنا، لن ينزل علينا من السماء أو من استنساخ تجارب الآخرين. التغيير الحقيقي للنظام التعليمي لا بد أن نزرعه بأيدينا، ونسقيه بأيدينا، ونحصده بأيدينا.