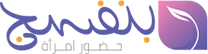ترى كاميلي باليا في كتابها أقنعة جنسية أن "دورات الطبيعة هي دورات المرأة. فالأنثوية البيولوجية تنتج من نوبات العودة الدائرية، تبدأ وتنتهي من وإلى النقطة نفسها. حيث مركزية المرأة تمنحها استقرار في الهوية. فهي ليست مضطرة لأن تصبح، وحسبها أن تكون.
ومركزية المرأة تمثِّل عقبةً كؤودًا أمام الرجل، إنها تعوق بحثه عن الهوية. حيث يجب عليه أن يحوِّل نفسه إلى كائن مستقل، أي كائن متحرر من المرأة"[1]. وهذا التفسير الطبيعي للشكل الذي يتخذه التفكير الوجودي للمرأة، أو التفكير الذي يتم عن طريق الجسد نفسه دون واسطة لغوية، يمكن أن نناقش من خلاله آراء دي بوفوار في الوضع الوجودي للمرأة التابع.
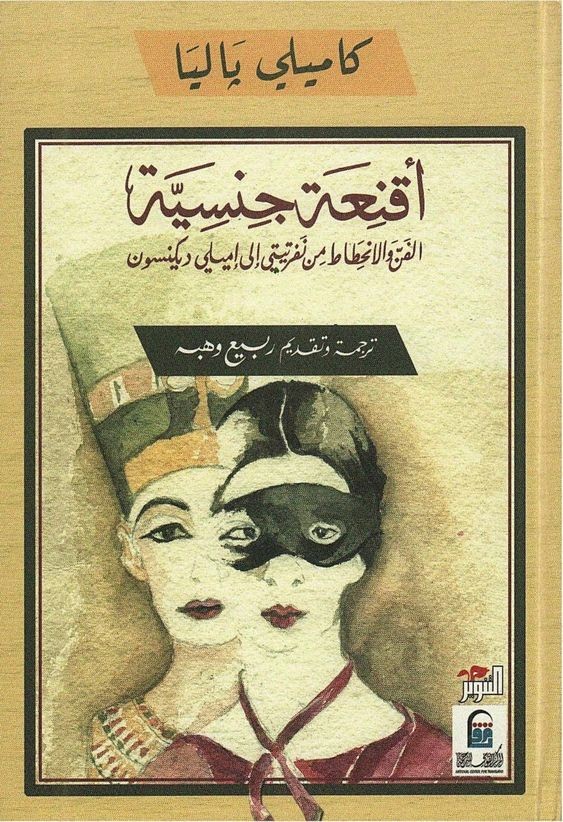
إن جسد المرأة -حسب كاميلي- لديه وعي خاص بالزمن، أو إن الزمن ليس منفصلًا عنه وخارجه، إنه زمني في إحدى تشكلاته، لأنه متوافقٌ مع الطبيعة، يتشكَّل في دورات، لا يتجاوزها، لذا، فإن معضلة "الزمن" التي هي إحدى الأسئلة القلقة في التفكير الوجودي ليست محلولة لدى المرأة بالتأكيد، لأن الإنسان لم يجد حلًا في صراعه مع الزمن، لكنها مفروغٌ منها بفعل الجسد، ولا جدوى من التفكير فيها، لأنها تتمثل في كل دورة طبيعية من أدواره، متوافقةً مع الطبيعة، لا تتجاوزها إلى التفكير فيها عبر اللغة.
وهكذا، فإن ما يبدو "جمودًا" و"سكونًا" لدى دي بوفوار، يصبح "هويةً" لدى كاميلي، تجعل المرأة لا تنافس من أجل هوية، ولا تتطلع إلى تجاوز وضعه الوجودي إلى حريةٍ أخرى، بينما الرجل يفعل ذلك لأن جسده ليس طبيعيًا بما يكفي، ولا متوافقًا مع الزمن الطبيعي، إنه يستعير عقله ليفكر في الزمن، بينما يجسد الجسد الأنثوي زمنه بلا لغة عبر دوراته المغلقة.
وبناءً على هذا التصور الطبيعي للجسد الأنثوي، فإن "الإرادة الحرة" التي تنشدها دي بوفوار عبر أفكارها الوجودية تصبح غيرَ ذات معنى، ترى كاميلي أن القدماء قد عرفوا "أن المرأة مربوطة بتقويم الطبيعة، بموعدٍ لا تملك رفضه. والنموذج الإغريقي للإرادة الحرة في الاختيال hybris بالتراجيديا يمثِّل دراما ذكورية.
فالمرأة -إلى وقتٍ قريب- لم تنخدع يومًا بسراب الإرادة الحرة. فهي تعرف أنه لا توجد إرادة حرة، نظرًا لكونها غير حرة، إنها لا تملك خيارًا، بل عليها القبول. وسواءً كانت ترغب في الأمومة أم لا، فإن الطبيعة تضعها تحت نير القانون التناسلي البهيمي ذي الإيقاع المتصلب. وتمثل الدورة الشهرية أو دورة الطمث ساعة تنبيهية، لا يمكن إيقافها إلى أن تريد الطبيعة ذلك"[2].
| تجربة أخرى..تنظير آخر

إن نظرة كاميلي لسيطرة الشرط البيولوجي على المرأة بالكلية بحيث يجعل المرأة "لا تحلم بالهروب المتعالي أو التاريخي من الدورة الطبيعية"، إنها نظرة مغالية في تقدير الجانب الطبيعي من المرأة واختزالها فيه، غير أنه المهم هنا هو أنه تنظير "امرأةٍ" أخرى، في مقابل تنظير دي بوفوار، وهو يصل بنا إلى مفهوم خصوصية التجربة، التي تجعل من الخطاب التعميمي في الحالتين "قمعيًا"، وأكثر سلطوية من الهيمنة الذكورية ذاتها؛ لأنها تأتي كصوت داخلي، يصادر الأصوات الأخرى عبر تعميم تجربته، وهكذا يُخلَق آخر مختلف، إنه ليس ذكوريًا، بل امرأة أخرى. وهذا لا يفكك مقولة "المرأة" بل إمكانية انسجام الخطاب حولها، أو تعميمه.
وبالعودة إلى دي بوفوار، فإن تنظيراتها بشأن المرأة ليست أقل قلقًا، فهي تعترف كون "جسد المرأة هو أحد العناصر الأساسية للوضع الذي تحتله في هذا العالم. ولكنه أيضًا لا يكفي لتعريفها؛ ليست لديه حقيقة معاشة إلا كما يتخذه الشعور عبر أعمال وضمن مجتمع، ولا تكفي البيولوجيا لإعطاء إجابة عن السؤال الذي يشغلنا: لماذا تكون المرأة هي الآخر؟ إن الأمر يتعلق بمعرفة كيف تمَّ استرجاع الطبيعة فيها عبر التاريخ؛ يتعلق الأمر بمعرفة ما فعلت البشرية بأنثى الإنسان"[3].
ولكنها ورغم تأكيدها على هذا التأثير المحدود للبيولوجيا، نراها في موضعٍ آخر تتحدث عن "مأساة المرأة" المتمثلة في "هذا الصراع بين المطالب الأساسية لكل ذات تطرحُ نفسها دومًا كأساس، ومتطلبات وضعٍ يجعلُ منها غير أساس"[4].
إن هذا الوضع الذي يجعل منها "غير أساس" سيبقى مجهولًا، ولن تجيب عنه دي بوفوار في كل محاولاتها التنظيرية بأكثر من إجابة شديدة العجز، وهي: لنرجع إلى التاريخ ونرَ لماذا تحوَّلت المرأة إلى "آخر"، وعلى العكس، يمكن أن توقعنا هذه الإجابة في فخ التحليلات الداروينية الاجتماعية التي ستفسرها وفق مبدأ الانتخاب الطبيعي الذي سينتصر بدوره للتفسير البيولوجي، أو التحليل الأنثروبولوجي الوظيفي أو البنيوي الذي سيردها إلى تقسيم الأدوار الاجتماعية. وهذا التقسيم سيكون مبنيًا هو الآخر على تفسير بيولوجي، المرأة تحمل وتلد، فتنحصر في هذه المهمة وما يتبعها، والرجل يخرج للمجال العام، والعام يسيطر عليها بوصفها مجالًا يوميا خاصًّا ومحدودًا.
مثلًا أول تفسيرات كلود ليفي ستروس لبنية تحريم زواج المحارم كانت فكرة "التبادل"، أي إن الرجال يتبادلون النساء اللواتي يملكوهن لكي يقيموا علاقات مع الآخر، وهو تفسير يحيل إلى ملكية الرجل للمرأة وإمكانية تبادلها كبنية راسخة.
تدرك دي بوفوار هذا التناقض وخطورته، لذا، فإنها تؤكد في موضع آخر أنها لا تسعى لإيجاد وضع أكثر راحةً للمرأة، بل أكثر حرية، تقول: "هذا يعني أننا باهتمامنا بفرص الفرد لن نعبِّر عن هذه الفرص بلفظة السعادة بل بلفظة الحرية[5]".
وهذا التركيب، ليس السعادة بل الحرية، يظهر تناقضًا بين ما يجعل المرء سعيدًا، وإن كانت الحرية مرتبطةً بالقلق كما نظّر الوجودين الذين أعلوا من قيمة القلق كشعور، وإن كان الشعور بهذه الحرية لا يؤدي في نهاية الأمر إلى السعادة؟ لا بدَّ أن مفهوم الحرية لدى دي بوفوار ليس سوى النتاج التنظيرات الوجودية عن المسؤولية والإرادة ومن ثم حرية الإرادة، وهو مفهوم غامض وطوباوي إلى حدٍّ ما، يُشّكُ في إمكانية تحققه وإدراكه.
| لا أنثى ولا ذكر، لا امرأة ولا رجل
وإذا كانت دي بوفوار قد أثبتت التمايز الجنسي، وناقشت القيم الاجتماعية التي تمنح للجنس البيولوجي، فإن جوديث بتلر تذهب إلى أبعد من ذلك، فترى أن الشخص "لا يولد أنثى، الشخص يصبح أنثى، بل وعلى نحوٍ أشد راديكالية، في وسع الشخص أن يختار، أن يصبح لا أنثى ولا ذكرًا، لا امرأة ولا رجلًا"[6].
لقد ذهبت بتلر إلى أبعد من افتراضات دي بوفوار حول دور الثقافة والقيم الاجتماعية والأخلاقية ودورها في خلق الذات، أو "الجندر" الخاص بها. والجندر هو "التأويل الثقافي المتغير للجنس، فإنه يفتقر إلى سمة الثبات والانغلاق التي تميِّز الهوية البسيطة. أن تكون جندرًا سواء رجلًا أو امرأة أو غير ذلك، هو أن تكون منهمكًا في تأويل ثقافي مستمر للجسد، وبالتالي أن تكون متموضعًا بشكلٍ ديناميكي داخل حقل من الإمكانات الثقافية"[7].
تذهب جوديث بتلر إلى أن الشخص "لا يولد أنثى، الشخص يصبح أنثى، بل وعلى نحوٍ أشد راديكالية، في وسع الشخص أن يختار، أن يصبح لا أنثى ولا ذكرًا، لا امرأة ولا رجلًا
تركز بتلر على فكرة "الأداء"، بمعنى أن الأفراد يؤدون أدوارًا تتناسب مع القيم الثقافية المتراكمة عبر التاريخ، الاجتماعي والأخلاقي والديني عن الكيفية التي يجب أن يبدو عليها الرجل أو المرأة، فهي ترى أننا رجالا ونساء "نتصرف كما لو أن كوننا رجلا أو امرأة هو حقيقة لواقع داخلي، أو شيء ببساطة صادق: حقيقتنا، في الحقيقة إنها ظاهرة، كونك تصنع دائمًا وتستنسخ دائما، لذا عندما نقول إن الجندرية سلوك تفاعلي، يعني ذلك أنه لا أحد يحمل هذه الجندرية منذ البداية"[8].
والسلوك التفاعلي وأدائية بتلر تذكِّر بنظرية الأقنعة لدى ارفنج جوفمان الذي افترض بأن الذات تكوِّن صورتها من خلال مجموعة من الأقنعة لأجل إدارة الانطباع حولها عبر عملية واعية تمامًا، تصبح فيها عملية التفاعل الجماعي أشبه بمسرح يتنوع فيه أداء الفاعلين الذي يختلف بحسب موقع ظهوره على هذا المسرح، وخطورة نظرية الأقنعة أنها تهدد فكرة وجود ذات حقيقية وأخرى مزيفة وراء القناع الذي تتخذه بسبب مواقف اجتماعية معينة، وهي الفكرة التي تتطرف في إشكالية الجندر، حيث تبرزه بتلر بوصفه أحد هذه الأقنعة التي لا تتكون بفعل المواقف الاجتماعية الطارئة، بل بفعل الثقافة المتراكمة التي تصبح حقيقة، وهي من القوة بحيث تنفي عن نفسها فكرة القناع أصلًا.

وهنا فتحت الباب لإمكانية التحولات التي لا تخص المرأة وحدها، بل فكرة "الجنس" نفسها، بغض النظر عن الرجل والمرأة، ولكن كون الخطاب صادر عن امرأة، فإن التلقي يتم في هذا السياق، وإن الأمثلة التي تضربها بتلر في عملية "التأويل الثقافي" المستمرة للجنس غالبًا ما تتجه نحو المرأة، وتناقش كقضية نسوية لا كقضية ذكورية، رغم أن بتلر نفسها لم توجهها في سياق نسوي -بالمعنى التقليدي- لكن حتى الآن يثير الجندر إشكالًا لأنه يمس الجسد الأنثوي كما يمس الكائن الثقافي الأنثوي، وهو ما يثير القلق مباشرة بشأن العائلة.
هذا القلق بشأن "مؤسسة" العائلة، والشكل الذي يمكن أن تكون عليه في حال تم الاعتراف بكل تبعات فكرة الجندر، من زواج المثليين وقانونية عمليات التحويل الجنسي لأسباب تتعلق بالرغبة دون وجود دواعٍ صحية، وتوسيع فكرة الحرية الجنسية اتساعًا غير مسبوق.
إن هذه القضايا الإشكالية والمثيرة للمخاوف الأخلاقية، هي التي تدفع بالحوار لأن يكون خاصًا بالمرأة بشكلٍ أكبر، بوصفها الجسد الذي يتم من خلاله التكاثر، ومن ثم الرعاية الأولية للطفل في عاميه الأولين، قد يكون تخلي الرجل عن وظيفته الذكورية مقلقًا، لكنه ليس بقدر تخلي المرأة عن وظيفتها الأنثوية البيولوجية من خلال الإنجاب، والعاطفية عبر شعور الأمومة، لذا تهتم النقاشات ذات التوجهات الأخلاقية بمناقشة مسألة الجندر كمسألة تخص المرأة، أكثر من كونها تلغي ثنائية الرجل والمرأة أصلًا، وهذا ما فعله عبد الوهاب المسيري مثلًا.
[1] كاميلي باليا، أقنعة جنسية، ترجمة ربيع وهبة (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2015)، ص 37
[2] المرجع نفسه، ص 38
[3] دي بوفوار، الجنس الآخر (الوقائع والأساطير)،ص 60
[4] المرجع نفسه، ص 28
[5] المرجع نفسه، ص 28
[6] نقلًا عن: جون ستوري، النظرية الثقافية والثقافة الشعبية، ترجمة صالح أبو أصبع وفاروق منصور (أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، كلمة، 2014)، 259
[7] جوديث بتلر، "الجنس والجند في الجنس الثاني لسيمون دي بوفوار، دراسات ييل الفرنسية، عدد 72 (1968)، ص 35-49، ترجمة لجين اليماني، https://nthar.net/wp-content/uploads/2016/03/judith.pdf
[8] مقابلة مع جوديث بتلر، تاريخ الدخول: 21 مايو 2018